تحذير وإخلاء المسؤولية: المحتوى الذي أنت على وشك قراءته يحتوي على تجارب مصورة وحساسة لحرب السودان. تعكس الآراء الواردة في هذه المقالة آراء المؤلف فقط وليس آراء أندريا. ننصح القارئ بالتقدير وحرية الإختيار. اقرأ إشعارنا التحريري الكامل هنا.
في أيام الحرب الأولى، تحت وطأة نيران المدافع وأصوات الطيران الحربي، يصبح من الصعب التركيز على أي شيء بخلاف محاولة النجاة والبقاء على قيد الحياة والحفاظ على من تحبهم بأمان؛ وفي هذه الأثناء بالتحديد بينما كان العالم يترقب بقلق ما يجري في السودان، نظراً لانعدام الفهم والرؤية الأوضح للموقف العام من الحرب وأسبابها، وفي انتظار طال لخروج النخب الثقافية ببيان واتخاذ مواقف، وفي محاولة منهم لفهم مجريات الصراع الدائر وتحليل أوضح لأسباب الصراع المنطقية، في هذه الأوقات الحرجة بالتحديد التي كان الجميع فيها يحاولون النجاة، كانت تُنصب الفخاخ وتعلق المشانق لأي محاولة مستقبلية لاتخاذ مواقف مناهضة للحرب.

المصدر: أحمد العطا
وبعد ذلك استفاق المثقف على انهيار الحياد واستحواذ عقلية الحرب على الجميع واصطفاف الأفراد خلف الأطراف المتحاربة، أحدهم اعتمر قبعة الوطنية وجعل من الحرب مصير حتمي لا بديل له كآخر مؤسسة وطنية للدولة، مبرراً موقفه واستمراريته في الحرب كمدافع عن سيادة الدولة، وحماية المواطن من عدو شبه خارجي. بينما تذرع واحتمى الآخر بموقف المناهض للحرب في سعيه للاصطفاف حول المنادين بقضايا التهميش الجغرافي التاريخي، في محاولة فاشلة منه لصنع كتلة توفر له القبول العام لدى المدنيين، مبرراً استمراريته بسعيه لتحقيق الديمقراطية. في حرب أبريل، كان استهداف المثقفين وسلبهم صوتهم في إبداء آرائهم واضحاً من الطرفين، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حيث كانت كل الآراء والتحليلات معدة مسبقاً وعليك الاختيار فقط خوفاً من سحب صكوك الوطنية.

المصدر: أحمد العطا
قصدنا بالمثقف هنا المصطلح المترجم من السياق الأوروبي في التاسع عشر الـ"Intellectual"، الذي يشير إلى الشخص المتخصص الذي يتجاوز مجال تخصصه ليخوض في القضايا العامة، والجدير بالذكر أن هذا المصطلح ظهر إلى العيان على يد الأديب الفرنسي اميل زولا مع حادثة الضابط اليهودي الفرنسي الذي تم اتهامه زوراً إبان تفشي العداء للسامية في أوروبا القرن التاسع عشر فقام عدد من المثقفين من بينهم زولا بتوقيع عريضة سياسية انتقدوا فيها العداء للسامية.

ايميل فرانسو زولا - المصدر الجزيرة.نت
وقد استخدم النقاد هذا المصطلح بكثافة للدلالة على سلطة ضميرية تستمد شرعيتها ليست من المكانة الاجتماعية القائمة على الإنجاز العلمي والأدبي فقط بل أيضاً من اتخاد موقف نقدي من ممارسة السلطات والآراء المسبقة الرائجة في المجال العام، حيث يجمع بين التفكير العقلاني والتحليل العميق والمواقف القيمية والأخلاقية تجاه القضايا المجتمعية.
وفقاً لعزمي بشارة، هناك نوعان من المثقفين؛ المثقف المحافظ والمثقف الثوري، يرى أن المثقف المحافظ قد يتحول إلى إصلاحي، وإذا فشل في تحقيق أهدافه قد يصبح انتهازياً أو يعود ثورياً. وفي سياقنا الحالي، نجد أن المثقف المحافظ الوطني غائب بشكل واضح. أما المثقف الثوري؛ فقد تعامل مع الحرب بشكل مختلف، حيث اعتبرها نوعاً من العمل الطوعي، وركز على مواصلة دوره المدني تجاه مجتمعاته؛ وفّرر أساسيات الحياة، وساعد في تنظيم ما تبقى من مجتمع الحرب، حيث شكل غرف الطوارئ وأعاد تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في الأحياء. في المقابل، يبدو أن المثقف المحافظ كان منقاداً من قِبل الجماهير، وهو ما ينعكس في أن الحرب الحالية تسيطر عليها شعارات شعبوية ويحركها استبداد العامة.
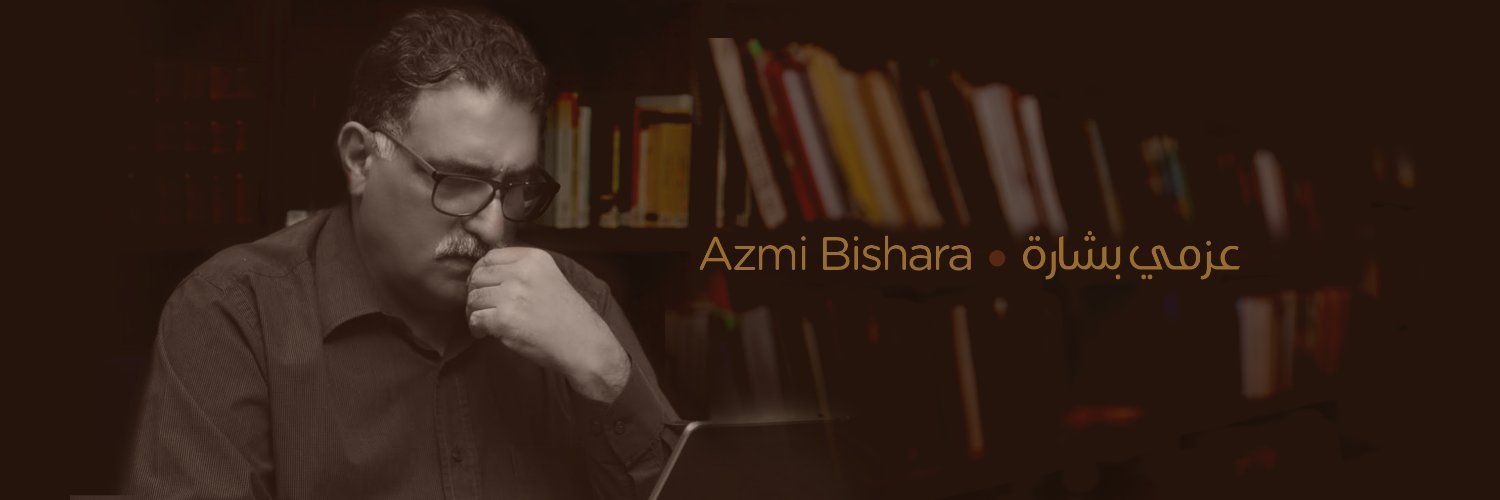
عزمي بشارة - المصدر صفحته على تطبيق إكس
كل هذا يقودنا ويعكس لنا ضعف المثقف المحافظ وافتقاره الرصانة الفكرية، مما أدى إلى انقياده بدلاً من قيادته للمجتمع، واكتفى بمحاولة إثبات وجوده من خلال التحليق والقفز فوق المواقف. هذا الوضع يبرز حاجتنا المستمرة لما أطلق عليه عزمي بشارة "المثقف العمومي"، وهو المثقف الذي ينحاز إلى الديمقراطية ومبادئها العامة، دون أن ينحاز لطرف معين، لأنه المصلحة العمومية تأتي عنده قبل كل شيء.
قامت بعض المحاولات الفاشلة لاستعادة صوت المثقف واتفقت مجموعة من النخب الثقافية والسياسية وفاعلي المجتمع المدني على تكوين جبهة موحدة لوقف الحرب بإسم الجبهة المدنية لإيقاف الحرب باتخاذهم موقف عام تحت شعار "لا للحرب"، دون وعي بما بعد الوقوف وإعادة نفس سيناريو ثورة ديسمبر باستخدام شعار "تسقط بس".
على ماذا تقف الحرب؟ يضعنا السؤال أمام المثقف بظروفه التي يفتقر فيها إلى الرصانة وضمور أدوات التحليل إلى إجابة أنتجت صورة طفولية متخيلة عن حرب عادلة أو أطراف متساوية و حتى قراءة وتحليل استباقي عن كيف أُعداد فخ لهذا الشعار، أدى في النهاية إلى فقدان أهم منصة وجبهة بإمكانها المساهمة في وقف هذه الحرب. رغم انه زمنياً لم يمر وقت على تكوينها إلا أنها كانت سبب آخر في سلب صوت المثقف مجدداً باختطاف المثقف الانتهازي للمنصة وانحيازهم لمصالحهم الشخصية و مكاسبهم السياسية لأحد الأطراف والتلاعب ببعض الحقائق، "لطالما كانت الضحية الأولى في الحرب هي الحقيقة".
كمثقفين في مثل هذه أوقات يجب أن نتجنب هشاشة السقوط الأخلاقي للقيم، ونعي ونتعامل مع قضية اتخاذ الموقف الأخلاقي ضد الصراع أمراً بالغ الأهمية، لكن الحقيقة التي تبينت أن كل النخب المثقفة إنما هي انتهازية؛ ومارست ما تجيده بانحياز لمصالحها، أو وسمت بالجُبن وامتنعت عن الانخراط دون تحيزات أو بيان أخلاقي واكتفت بالنظر فقط. ولم تعي أن أهم دور للمثقف في هذه الأوقات هو الانتباه لمصلحة المدنيين والتوعية بمدى فداحة استمرار الحرب، واستغلال نفوذهم لتعزيز السلام وتشجيع الحوار والدعوة إلى حلول غير عنيفة، والمساهمة في إنهاء الصراعات ومنع المزيد من العنف.
لا للحرب
موقف لا للحرب تاريخياً ليس بالجديد، أثناء حرب الخليج، وقَع نعوم تشومسكي ومثقفون آخرون على رسالة تدين الحرب وتدعو إلى حل سلمي. وفي الحرب الأهلية الإسبانية، إنضم العديد من المثقفين من جميع أنحاء العالم إلى الألوية الدولية لمحاربة الفاشية. وفي حرب العراق، شكلت مجموعة من المثقفين البريطانيين تحالف "أوقفوا الحرب" للاحتجاج على الحرب. خلال الحرب الأهلية السورية، اتخذ العديد من المثقفين مواقف مختلفة بشأن الصراع، حيث دعم البعض المعارضة والبعض الآخر دعم الحكومة.
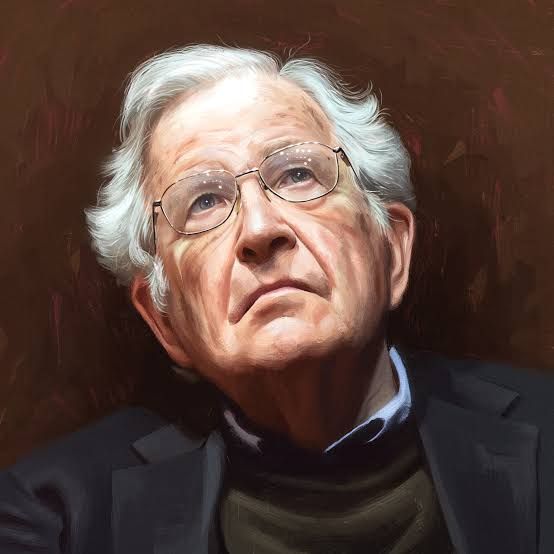
نعوم تشومسكي - المصدر نيويورك تايمز
كمثقف، فإن اتخاذ موقف بشأن جانب معين من الحرب يمكن أن يكون له آثار أخلاقية كبيرة. فمن ناحية، قد يشعر البعض بالتزام أخلاقي بالتحدث علناً ضد الفظائع التي يرتكبها الدعم السريع تجاه المدنيين في كل مناطق سيطرته. ويمكن اعتبار ذلك وسيلة لتعزيز العدالة ومنع المزيد من الضرر تجاه المدنيين. ومع ذلك، فإن الانحياز يمكن أن يعني أيضًا أن المثقف يدعم العنف ويساهم بشكل غير مباشر في معاناة أولئك الذين وقعوا في مرمى النيران، وهو ما يمكن اعتباره غير أخلاقي. لذلك؛ من المهم أيضاً التفكير بعناية في عواقب أفعالهم وتأثيرها على مجريات الصراع.
بالرغم ذلك، من المهم ملاحظة أن المثقفين ليسوا مجموعة متجانسة، ويمكن أن تختلف استجاباتهم للحرب اختلافاً كبيراً. من غير الضروري أن المثقف دوماً على حق، قد يساهم في حشد الناس لطرف ضد أخر وقد يكون ضحية لأيديولوجيا وناجياً من نقيضه. في الحرب تحديد ما هو صواب أو خطأ أمراً معقداً فمن الصعب على المثقفين أن يظلوا محايدين تماماً، وقد تتأثر وجهات نظرهم بمعتقداتهم وقيمهم. إلا أنه من المهم أن يسعوا إلى الموضوعية والنظر في وجهات نظر متعددة.
في نهاية المطاف، فإن مفهوم الصواب والخطأ في الحرب هو مفهوم ذاتي ويعتمد على وجهات نظر فردية، في بعض الأحيان ينظر المثقفون الماركسيون إلى الحرب على أنها نتيجة للإمبريالية الرأسمالية ويدعمون الحركات المناهضة للحرب، ومن ناحية أخرى؛ قد يدعم المثقفون المحافظون التدخل العسكري في مواقف معينة، كحماية لمصالح الأمن القومي. على كلٍمن الصعب أن نخرج بموقف موحد حول الحرب الحالية، إلا أن ضرورة المحافظة على هذه الأصوات المتباينة على قدر عالٍ من الأهمية، وأصواتهم ضرورية في تعزيز الحوار والتفاهم.
الآثار
لطالما كان للحرب تأثير عميق على المثقفين على مر التاريخ، من صدام الأيديولوجيات إلى تدمير التراث الثقافي وفقدان الأرواح البشرية كلها جوانب تثير قلقاً عميقاً للمثقفين. تاريخياً، تباينت مواقف المثقفين تجاه الحرب، حيث منهم من عارض الحرب ومنهم من شارك في دعم آلية الحرب كجنود و مخططين عسكريين. تأثر المثقفون بسياقات تاريخية وثقافية مختلفة في مواقفهم الأخلاقية من الحرب. على سبيل المثال، إذا عدنا قليلاً إلى الوراء ونظرنا إلى حرب الجنوب، سنجد أن ضعف المثقف وغياب الرصانة الفكرية، بالإضافة إلى عدم استشعار المصلحة الوطنية، ساهمت في نشوء تيارات متضاربة حول الكيان الوطني. وتزايدت خطابات الاستقطاب الهوياتي، مما أدى إلى تفكك المجتمع وظهور انقسامات عمودية عمقت الشرخ الاجتماعي، وحولت حرب الجنوب في أذهان الشماليين والجنوبيين إلى ما يُشبه حرب إبادة.
لكن لا يمكن تحميل المثقف السوداني وحده مسؤولية هذه الأحداث؛ لأن المثقف كما يقول البروفيسور عبد الله علي إبراهيم بعامية ساخرة أنه كان مجرد (حارس فروة) أي أن دوره في المنظومات السياسية ليس صناعة الأجندة بل إعطاء مشروعية ثقافية لأجندة يصنعها سياسيون يتعاملون مع السياسية كعملية تقوم على الفهلوة والخديعة بعيداً عن التشريد المعرفي أو الأخلاقي.
يمكن القول أيضاً أن هناك عوامل استعمارية أسهمت في اشتعال حرب الجنوب تتمثل في طرائق تنشئة المثقفين التي اعتمدها المستعمر كان لها تأثير كبير فقد أرسل المستعمر الإنجليزي النخب الجنوبية للتعليم في الإرساليات في شرق أفريقيا، بينما كانت النخب الشمالية تتلقى تعليمها في القاهرة. هذا الأمر عزز الشروخ الثقافية في المجتمع السوداني وأدى إلى الانقسامات التي عايشناها حتى الانفصال. إضافة إلى ذلك، ضعف اقتصاديات المعرفة ساهم في تحول الجامعات من دراسة المجتمعات وتحليلها إلى مجرد مختبرات تدريس المناهج النظرية.
و قادنا ذلك إلى نمطين من المثقفين: الأول هو المثقف المرتبط بالمنظمات غير الحكومية التي تعتمد على تمويل مشروط بأجندات وقضايا محددة، والثاني هو المثقف الحكومي الذي يعمل في إطار الاستبداد، حيث تكون المخرجات في الغالب رديئة، خصوصاً مع اعتماد الجامعات على المحسوبية والولاء السياسي في آليات التعيين.
وعالمياً خلال الحرب العالمية الأولى، آمن العديد من المثقفين بفكرة الحرب العادلة ودعموا بلدانهم، إلا أنهم بعد الحرب، أدت أهوال الصراع إلى تحول فكرهم نحو السلام والمشاعر المناهضة للحرب. في المقابل، خلال الحرب العالمية الثانية، اعتقد العديد من المثقفين أنه من الضروري محاربة الفاشية والشمولية، مما أدى إلى موقف أخلاقي مختلف من الحرب. كما كان لعصر الحرب الباردة تأثير كبير على المواقف الأخلاقية للمثقفين من الحرب؛ انقسم العديد من المثقفين بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي، مما أدى إلى مناقشات حول أخلاقيات استخدام الأسلحة النووية وسباق التسلح. وتباينت الآراء كأفراد دون مجتمع المعرفة كمثال لذلك، كان ألبرت أينشتاين من دعاة السلام وعارض الحرب العالمية الأولى والثانية، وقام جان بول سارتر بدعم المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. وكان برتراند راسل ناشطاً بارزاً مناهضاً للحرب خلال القرن العشرين. وقد شارك العديد من المثقفين في احتجاجات حرب فيتنام في الولايات المتحدة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
ظل موضوع الحياد خلال أوقات الحرب أو الانحياز إلى أحد الجانبين نقاش عبر التاريخ للمثقفين، ويزعم البعض أنه من المستحيل البقاء على الحياد وأن الانحياز إلى أحد الجانبين أمر ضروري، بينمايرى البعض الآخر، مثل حنة أرندت، أن المثقفين يتحملون مسؤولية التحدث علناً ضد الظلم والعنف، حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ مواقف لا تحظى بشعبية.
خاتمة
لطالما كانت الحرب تحدياً حقيقياً من الناحية الأخلاقية والمعرفية أمام المثقفين في العالم، والسودان ليس استثناءً. المثقف السوداني، يجب أن ينهض بدوره في إنتاج معرفة جدية تعتمد على ما توفره العلوم الاجتماعية من أدوات ومفاهيم تحليلية لمقاربة واقع حرب ١٥ أبريل وربطها بالسياق التاريخي الطويل لحروب دولة ما بعد الاستعمار. وهذا يحتم عليه أن يكون في مواجهة دائمة مع القوى السياسية والاجتماعية التي تحاول إسكاته أو توظيفه. فاليوم، بات من الضروري أن يستعيد المثقف دوره الحقيقي في توعية المجتمع، ونبذ العنف، والعمل على بناء جبهة ثقافية تعمل على صنع سلام استراتيجي بعيداً على الحلول المتجزأة والمؤقتة.
