تحذير وإخلاء المسؤولية: المحتوى الذي أنت على وشك قراءته يحتوي على تجارب مصورة وحساسة لحرب السودان. تعكس الآراء الواردة في هذه المقالة آراء المؤلف فقط وليس آراء أندريا. ننصح القارئ بالتقدير وحرية الإختيار. اقرأ إشعارنا التحريري الكامل هنا.
في الخامس عشر من أبريل 2023، انقلبت حياة ملايين السودانيين رأساً على عقب. كانت بداية حرب غيّرت ملامح الوطن، وأزهقت أرواحاً بريئة، ودفعت أجيالاً كاملة إلى النزوح واللجوء، وأجبرت الشباب على مواجهة مصائر لم يختاروها.
بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في 3 مايو 2025، تجاوز عدد المتأثرين بالنزاع 12.7 مليون شخص، بينهم نحو 8.8 مليون نازح داخل البلاد، وأكثر من 2.7 مليون لاجئ فرّوا إلى دول الجوار وخارجها. هذه الأرقام، على قسوتها، لا تكشف كل شيء؛ فخلف كل رقم قصة إنسانية تحمل في طياتها الخوف، والفقد، وصراع البقاء.
على أرصفة القاهرة، وفي منازل مكتظة في كمبالا وتشاد وليبيا، تتناثر قصص مؤلمة لشباب وجدوا أنفسهم فجأة بين مطرقة الحرب وسندان المنافي. بعضهم كان يحلم بمشاريع تعليمية أو مهنية، وآخرون كانوا على وشك التخرّج أو بدء حياتهم العملية، قبل أن تغتال فوهات البنادق أحلامهم وتحول واقع حياتهم إلى جحيم.

آلاف السودانيين تعرضوا إلى صنوف مختلفة من الانتهاكات من قبل عصابات تهريب البشر. المصدر: BBC News
من الخرطوم إلى شرق أفريقيا فليبيا: حكاية طالب من شمال دارفور
يسترجع هذا الشاب اللحظة الأولى قبل أن يبدأ بسرد قصته: "استيقظنا على أصوات المدافع في داخلية الوسط بجامعة الخرطوم"، هكذا بدأ الطالب السوداني (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) روايته. فخرج هارباً في شوارع شبه خالية، متنقلاً بين المواصلات والمشي حتى وصل إلى أم درمان.
بعد شهر ونصف، قرر المغادرة نحو دارفور: "قررت السفر خارج أم درمان لأني تأكدت أن هذه الحرب من الصعب أن تتوقف خلال أيام أو أسابيع، وأن فرص البقاء على قيد الحياة تتضاءل كل يوم". ويصف ملامح من رحلته إلى دارفور فيقول: "ركبت مع عدد من الهاربين من أم درمان على ظهر شاحنة من نوع Zs، كان بها حوالي 250 راكباً، واتجهنا نحو دارفور بعد رحلة دامت سبعة أيام رأيت فيها كل أنواع المعاناة في نقاط التفتيش؛ من أسئلة وتحقيق وحتى الضرب أحياناً".
استقر مؤقتاً في الفاشر، لكنه شعر أن المستقبل يضيق أكثر، فاختار الهجرة عبر جنوب السودان. يقول "قضيت أربعة أشهر هناك وسط الجوع والملاريا التي أصابتني أكثر من خمس مرات، فنقص وزني 13 كيلوغراماً. قررت العودة إلى السودان ومنها إلى ليبيا عبر التهريب. رجعت عبر مدينة الضعين، ومنها إلى الفاشر ثم مليط، ومنها عبر سيارات التهريب إلى مدينة الكفرة الليبية".

شباب سودانيين مهاجرين إلي ليبيا. المصدر: فيسبوك
ويصف مشاهد رحلة التهريب بين المخاطرة والأمل: "لا يمكن وصفها… كنا أشبه بالماشية على ظهر شاحنة، مربوطين بحبال داخل مشمّعة بلاستيك. ومن الكفرة واصلت السير إلى بنغازي، فاستقرّيت أخيراً هنا وبدأت أبحث عن عمل. عملت في عدد من الأماكن؛ في تجارة المواد الغذائية، والشركات، والمغاسل وغيرها. في أحيان كثيرة نتعرض للغش، حيث نعمل لشهور من دون مرتب؛ فصاحب العمل غالباً يتهرّب أو يرفض الدفع، مصحوباً بعدد من الشتائم. عوضاً عن مطاردات أجهزة الهجرة غير الشرعية الدائمة، حيث نعيش في الخفاء في المنازل وكأننا مسجونون لأيام".
وبنبرة تجمع بين الألم والإصرار يكمل: "حياتي الآن في ليبيا لا تعجبني، مليئة بالمتاعب والمآسي والحيرة، ولكن على الأقل، الحمد لله، أعتبر نفسي محظوظاً لأني ما زلت على قيد الحياة، ولا أتوقع سقوط قذيفة على رأسي مثل ما كان الوضع في أم درمان. أعمل جاهداً لتوفير متطلبات معيشتي وأفكر في بلد به استقرار وحياة أفضل".
اليوم يعيش في بنغازي، ويعمل في مهن مختلفة، لكنه يصف حياته هناك بأنها "نجاة من الموت، لا أكثر"، وسط عنصرية ومعاملة قاسية للمهاجرين.
ثلاث عشرة ليلة على الأقدام: رحلة طلال إبراهيم
طلال، شاب سوداني، عاش ثلاثة أشهر في الخرطوم بعد أن نزح معظم سكانها. انتقل إلى ولاية الجزيرة، لكن الحرب لحقته هناك، فهاجر إلى سنار، ومنها سيراً على الأقدام ثلاثة عشر يوماً نحو شرق السودان.
يروي طلال جزءاً آخر من الحكاية مليئاً بالمشاهد القاسية: "الموت كان أقرب إليّ من الحياة، رأيت الجثث في الشوارع، والكلاب تأكل الموتى".
وصل طلال إلى مصر محمّلاً بذاكرة مليئة بالدماء، بلا عمل، وبحياة يصفها بالمظلمة. رغبته في العودة إلى السودان تصطدم بذكريات الحرب التي تطارده. يرى أن الاستقرار السياسي في السودان "مجرد استراحة مؤقتة قبل حرب أخرى".

طلال إبراهيم في طريق الهجرة من السودان إلى مصر: المصدر طلال إبراهيم
شيماء: عندما تغتال البنادق أحلام العصافير
لم تكن شيماء أبو علامة تتوقع أن تتحول رحلتها القصيرة إلى السعودية، التي بدأت في نهاية عام 2022 لاستعادة أنفاسها وإعادة ترتيب أوراق حياتها، إلى محطة فاصلة قلبت مسارها بالكامل. كانت حينها مدربة تبحث عن تغيير في مسارها المهني، تطمح للانتقال إلى مجال جديد أكثر قرباً من شغفها، وقد وضعت خططاً دقيقة لعودتها إلى السودان بعد ثلاثة أشهر، لتبدأ دراسة الماجستير في الإعلام بجامعة إفريقيا العالمية، إلى جانب إطلاق مشروعها الخاص مع صديقتها.
تقول شيماء: "بعد أداء العمرة كنت أعيش أجمل لحظات العزلة الإيجابية، أستمتع بالهدوء وأخطط بدقة لما أريد أن تكون عليه حياتي المقبلة. كنت على وشك جني ثمار هذه الخلوة، لكن فجأة جاء الخبر كالصاعقة: الحرب اندلعت في السودان."

شيماء أبو علامة تؤدي مناسك العمرة بالسعودية. المصدر: شيماء أبو علامة
رغم أنها لم تكن موجودة جسدياً داخل السودان عند اللحظة الأولى لانفجار القتال، إلا أن أثره النفسي والعملي ضرب حياتها في الصميم. بين ليلة وضحاها، انهار مشروعها الناشئ، وتبخرت خططها الأكاديمية، وتحولت أحلامها إلى قائمة مؤجلة لأجل غير مسمى. زاد الأمر قسوة أن شهور الحرب الأولى كانت مليئة بالقلق على عائلتها وأصدقائها، مع عجز كامل عن العودة أو تقديم العون.
لكن شيماء لم تستسلم. وجدت في شغفها بالتعليق الصوتي نافذة أمل، فاستثمرت في تطوير هذه المهارة رغم الظروف. التحقت بمعسكر تدريبي عبر الإنترنت استمر ستة أشهر، تلقت خلاله تقييمات دقيقة من خبراء، كان أبرزهم مدربها الفلسطيني أحمد أبو سعده، الذي وصفته بـ "الموسوعة الصوتية"، وكان أول من زرع فيها بذرة هذا التوجه منذ عام 2021. لم يكن الأمر سهلاً؛ بدأت في بيئة جديدة بلا جمهور، والرؤية أمامها كانت ضبابية. تراكمت الضغوط، وانقطعت عنها فرص العمل، حتى أنها قضت تسعة أشهر في 2023 دون أي عائد مادي من هذا المجال، وهو ما ولّد لديها إحباطاً شديداً وشعوراً بأن صبرها كان بلا جدوى.
"كانت لحظات مظلمة،" تقول شيماء، "لكن وجود من يؤمن بي كان الفارق." كان الإعلامي السوداني المقيم في الخارج، مناضل عبدالله، أحد هؤلاء الداعمين، حيث شجعها على الاستمرار وعدم الاستسلام. وبالفعل، استطاعت أن تنهض من جديد، وسجلت أول عمل مدفوع في نهاية 2023. ومنذ ذلك الوقت، قفزت قفزات كبيرة في مسيرتها، حتى أصبحت مستشارة صوتية ومدربة تطوير صوت في 2024.
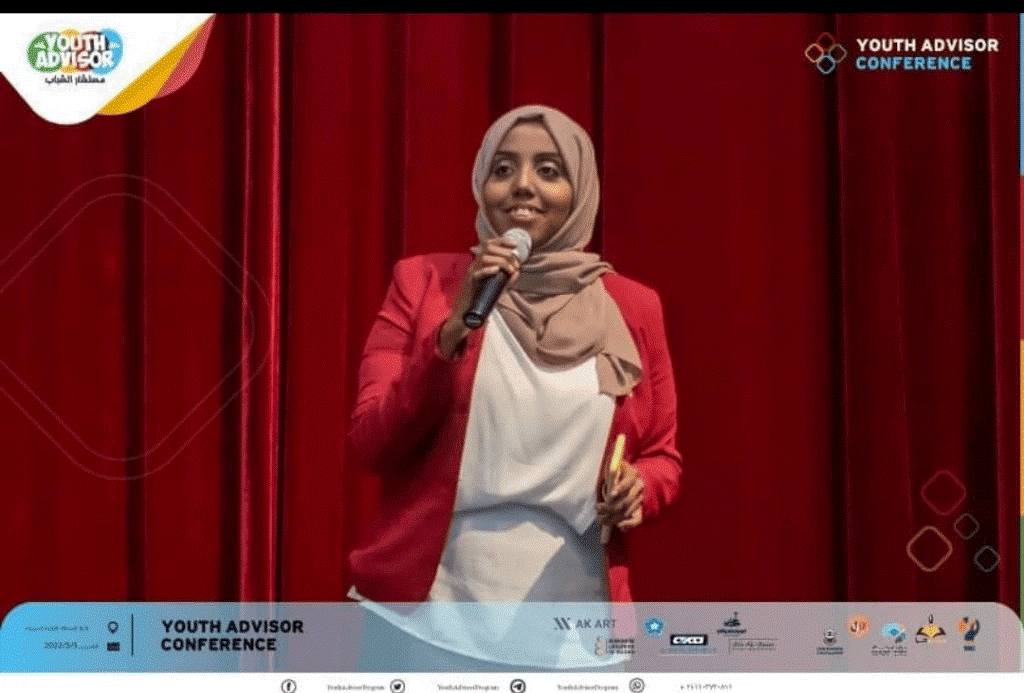
شيماء أبو علامة في مؤتمر مستشار الشباب قبل الحرب. المصدر: فيسبوك
ورغم أنها الآن تعيش حالة من الاستقرار المهني، إلا أن الحنين للسودان يظل حاضراً. أكثر ما تفتقده هو "راحة البال" وسهولة الوصول إلى بيئة داعمة يمكنها من خلالها تطوير عملها. تقول: "الغربة مهما وفرت من رفاهية، لا تستطيع أن تمنحك رائحة السودان."
تخطط شيماء للعودة إلى وطنها يوماً ما، لكن ليس قبل أن تكون جاهزة بما يكفي لتقديم إضافة حقيقية للمجتمع الذي تركته خلفها مضطرة، على أمل أن تلتقي أحلامها المؤجلة بأرض الواقع، في بلد يتعافى من جراحه.
هكذا، تتوالى الشهادات، كل واحدة تكمل الأخرى، لتشكل لوحة كاملة لشتات شباب السودان في ظل واقع الحرب.
أيمن: حياة الهجرة مريرة ومليئة بالمعاناة والإذلال
بالنسبة لأيمن حماد، شاب سوداني في العشرينات، حاصل على دبلوم في تصميم الجرافيك، ونائب رئيس منظمة هيومنس هيل لحقوق الإنسان، فإن صباح 15 أبريل 2023 شكّل نقطة تحول جذرية في مسار حياته.
يقول أيمن: "كنت في المواصلات متجهاً نحو السوق العربي، سمعت فجأة دوّى إطلاق نار كثيف. توقفت الحافلة، وطلب السائق العودة، لكننا لم نبتعد كثيراً حتى أوقفتنا مجموعة من قوات الدعم السريع. بدأوا في تفتيش الركاب، خاصة ذوي البشرة الفاتحة." كانت اللحظة التالية صادمة. يروي "كنت برفقة شاب آخر. صادروا أموالي ومقتنياتي، ثم أطلقوا النار على الشاب فأردوه قتيلاً أمامي. أما أنا، فانهالوا عليّ بضربات بمؤخرة السلاح حتى فقدت الوعي." أفاق أيمن في مستشفى النو، ليكتشف أن أسرته كانت قد تلقت خبر وفاته. كان صوته على الهاتف صدمة مبهجة لهم، لكنها لم تمحُ مشهد الموت الذي ظل يطارده.
بعد فترة نقاهة قصيرة، قرر مغادرة الخرطوم نحو ود مدني. لكن اتساع رقعة الحرب وانعدام الأمان دفعاه لاتخاذ قرار لم يكن يوماً في حسبانه: الهجرة. يقول: "كنت أكتب مقالات ضد الهجرة غير الشرعية، وأراها طريقاً مدمراً… لكن الحرب دفعتني دفعاً إلى الطريق ذاته."
كانت مصر أول محطاته، لكن القاهرة لم تمنحه الاستقرار الذي أراده، فضيق المعيشة وغياب فرص العمل جعلاه يتجه نحو ليبيا، ومنها إلى أوروبا. وهنا بدأت رحلة جديدة محفوفة بالخطر والإهانة حسب وصفه: "من السلوم إلى أم ساعد، مشيت 12 ساعة على الأقدام. كنا نختبئ من الحراس، ثم نركض فوق الحصى حتى لا يتم القبض علينا. أحد المهاجرين تشاجر مع المهرب بسبب المال، فضربه الأخير وألقى به أرضاً، ثم وضع حذاءه على رأسه. في تلك اللحظة شعرت أن الموت أهون من هذا الذل."
لكن الوصول إلى ليبيا لم يكن نهاية المعاناة. بلد تمزقه المليشيات، حيث لا حماية للمهاجر ولا استقرار. عمل أيمن في محلات وشركات ومغاسل، وكثيراً ما كان يُحرم من راتبه أو يتعرض للإهانة. يقول "كنا نعمل لشهور، ثم يرفض صاحب العمل الدفع، بل ويشتمك"، يقول بمرارة. ومع ملاحقة أجهزة الهجرة غير الشرعية، كان أيمن يعيش أياماً متواصلة داخل المنزل، وكأنه في سجن مفتوح. ورغم كل هذا، لا يزال يحاول الوصول إلى أوروبا، متمسكاً بأمل التغيير، وإن كان الحنين للسودان لا يفارقه، "أفتقد كل التفاصيل… لمّة العائلة، جلسات الأصدقاء، حتى شارع النيل. نحن نغادر المكان، لكن القلب يبقى هناك."
الخاتمة
بهذه الشهادة، يختتم أيمن سلسلة حكايات جيل سوداني مزقته الحرب، ودفعته المنافي إلى طرق لم يكن يفكر يوماً في السير فيها. قصته، مثل قصص زملائه، تكشف أن النجاة في زمن الحرب قد تعني العبور من موتٍ إلى موت، في انتظار حياة مؤجلة لا يعرف أحد متى تأتي.
قصص الطالب الجامعي وطلال وشيماء وأيمن ليست استثناءً، بل نماذج لآلاف الشباب السوداني الذين أُجبروا على إعادة تعريف حياتهم بالكامل. الحرب لم تغير أماكنهم فقط، بل غيّرت علاقتهم بأنفسهم وبأحلامهم. في الداخل، يعيش النازحون في عزلة اجتماعية، بلا موارد كافية، يحاولون البدء من الصفر. وفي الخارج، يواجه اللاجئون تحديات الإقامة، واللغة، والعمل، والعنصرية. كثيرون منهم عالقون بين الحلم بالعودة والخوف من تكرار المأساة.
لكن رغم كل شيء، هناك من يحاول تحويل الألم إلى دافع. بعضهم أطلق مبادرات تعليمية صغيرة، وآخرون انخرطوا في مشاريع عمل حر، أو تعلموا مهارات جديدة. وبين التحديات وتطلعات المستقبل ما زالت جذوة الأمل مشتعلة، ولو بخيوط واهية.
"لسنا فقط ضحايا حرب"، تقول آلاء إسماعيل، ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان تعيش مؤقتاً في كمبالا، "نحن ناجون نحاول كتابة مستقبلنا بأدواتنا المحدودة".
حرب 15 أبريل لم تكتفِ بهدم المباني والبنية التحتية، بل هدمت أيضاً أحلام جيل كامل. ومع ذلك، يستمر شباب السودان في البحث عن طرق للبقاء، وإيجاد معنى لحياتهم رغم مرارة النزوح وتحديات المنفى. قد تكون العودة للوطن حلماً مؤجلاً، لكنهم يعلمون أن إعادة البناء تبدأ أولاً من الدواخل المحطمة، من الإنسان ومعاني الرحمة والتعايش قبل أن تبدأ من المباني.