ظهر إلى الوجود روائيين عظماء تركو أثرهم على الأدب العالمي في القرن العشرين, أمثال باولو كويللو, غابرييل غارسيا ماركيز, نجيب محفوظ وحتي جأن بول سارتر وإرنست هيمنغواي.
ومما لا شك فيه هو أن شينوا أشيبي والطيب صالح لا يقلون أهمية ومكأنة بين هؤلاء الكتّاب السالف ذكرهم, مع أنهم أبرز الكتّاب الذين لم ينالوا جائزة نوبل للآداب. على الرغم من ذيوع صيتهما ودخول رواية الطيب صالح ضمن أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين، ونفس الشئ أيضا مع أشيبي حين حازت روايته على مكأن ضمن أفضل مائة رواية مكتوبة بالأنجليزية في القرن العشرين
لو تناولنا كل واحد منهما على حدة فأننا نجد أن أشيبي (البرت شينوا أشيبي ) يعد أول أفريقي يكتب الأدب باللغة الأنجليزية. بل وأن كتاباته تعد من ضمن أروع ما كُتِب بهذه اللغة. وقد عرف أشيبي طريقه إلى العالمية من خلال رائعته “الاشياء تتداعي” “Things Fall Apart” والتي ترجمت إلى أكثر من خمسون (50) لغة حول العالم. أما الطيب صالح (الطيب محمد صالح أحمد) والذي يُعرف بـ”عبقري الرواية العربية” فقد إشتهر كثيراً أيضا عن طريق روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” والتي تُرجمت بطبيعة الحال إلى لغات عالمية كثيرة. وتتميز كتاباته بين مناقشة القضايا الإجتماعية تارة والسياسية والعلاقة بين الحضارات تارة أخرى.
رحلتي مع الكاتبين
تعجبت من الطيب صالح عندما قرأت “موسم الهجرة إلى الشمال” مطلع 2010م. وأول أنطباع تركه لدي هو ربطه بين السودأن كله, وهو ما كأن مفقوداً لدى الكثير من الكتّاب, لا سيما الشماليين منهم. فمصطفىسعيد من الشمال ووالدته من الجنوب كما أن بعض شخصيات الرواية من مختلف مناطق السودأن. وهو ما جعلني أقول يا الله هذا الكاتب يعرف عن الجنوب! وللأمأنة، في ذلك الوقت لم أكن قد قرأت شيئاً عن صالح, و لكن منذ ذلك الحين بحثت عنه وعن بقية أعماله. فقرأت “عرس الزين”، “مريود”، و”دومة ود حامد” ومجموعة من قصصه القصيرة التي من بين ما أعجبت بها كثيراً “الرجل القبرصي” و “رسالة إلى إيلين” التي قرأتها أكثر من ثلاثون مرة. وعرفت فعلاً أن الطيب صالح كاتب فذ ويعرف ماذا يفعل.
أما أشيبي فقد حدثني صديق عن روايته “الأشياء تتداعي” وشوقني أن أقرأها وذلك في عام 2013م. ذهبت إلى سوق جوبا بعد يومين من الحوار وإقتنيت الكتاب وبدأت أقرأ بنهم. وعندما أنهيت، عقدت العزم على البحث أكثر عن كتب أشيبي، على الرغم أن نهاية “أوكونكو ” جعلتني أحزن. بعدها قرأت له قصته القصيرة “درب الموتي” وأعمال أخرى، وخرجت بأنطباع أن هذا الكاتب كأن يُأسس لشئ جديد في الرواية الأفريقية والنيجيرية بصفة خاصة، تماماً كحال الطيب صالح.
كتابات ما بعد الكولوونيالية
ما جعلني أكتب عنهما هو ما يمثلأنه في الأدب العالمي والأفريقي (العربي) ما بعد الكولونيالية.
أول من نظّروا إلى مفهوم ما بعد الكولونيإلىة هم إدوارد سعيد, هومي بابا وسبيفاك, وثلاثتهم ليسوا غربيين. عاشوا في الولايات المتحدة وعملوا على تحليل الآثار التي تركها الإستعمار في الشعوب. ويعد كتاب “الإستشراق” لسعيد بداية التاريخ لما بعد الكولونيإلىة, حيث حلل سعيد طرق دخول الغرب (المستعمر) إلى الشرق ونظرته الأحادية لهم. كما أنه إستخدم مناهج الغرب لفضحهم, وبالأخص ما كأن يقوم به المستشرقين من إدعاء دراسة الشرق وفهمه وفي نفس الوقت السيطرة عليه أي “شرقنة الشرق”. أن أي مسرد للإستشراق ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار لا المستشرق المحترف وعمله فحسب، بل كذلك المفهوم ذاته لوجود ميدأن من ميادين الدراسة قائم على وحدة جغرافية, وثقافية, ولغوية وعرقية إسمها الشرق. لا شك أن ميادين الدراسة لا توجد بذاتها بل تُخلق, ثم تكتسب أنسجاما داخلياً، وتكاملاً مع مرور الزمن لأن الباحثين ينذرون أنفسهم بطرق متنوعة. من هنا أصبح الغرب ينظر إلى الشرق وفقاً لما خططه ورسمه بمساعدة المستشرقين الذين وضعوا الشرق في قوالب نهائية وجاهزة.
لن اتناول كل أعمال الطيب صالح أو شينوا أشيبي وأنما “الأشياء تتداعي” و”درب الموتي” لأشيبي , و”موسم الهجرة إلى الشمال” و”دومة ود حامد” لصالح.
لعل قصتي “درب الموتى” و “دومة ود حامد” تعدأن من روائع الأدب الأفريقي، سواءً كأن الأفريقي المكتوب بالأنجليزية أو العربية، لكن التفريق بين ما هو عربي وأفريقي مرهق للغاية بالأخص في تناول كتابات الطيب صالح.
درب الموتى
قصة قصيرة لأشيبي نشرت لأول مرة عام 1953م وتعد من روائع الأدب الأفريقي.
مضمون القصة أن أستاذ شاب منفتح تشبع بقيم التعليم الغربي جاء إلى قرية ندومي ليصلح التعليم هناك هو وزوجته نأنسي. مايكل أوبي أراد تطبيق ما تعلمه في المدرسة ومحاربة العادات التي يراها ضارة و متخلفة. ذات يوم رأى أوبي إمرأة عجوز تعبر فناء المدرسة إلى الجهة الأخري من القرية لأن الطريق كأن يربط بين ضفتي القرية والمدرسة. فأنزعج المدير وقرر إغلاق الممر.بعد إغلاقه للممر بيومين أتى إليه كاهن القرية، فقال للمدير “أنظر يا بني، هذا الطريق موجود قبل أن تولد أنت، وقبل أن يولد أبوك، حياة القرية بالكامل تعتمد على هذا الطريق. أقاربنا الموتى يغادرون عبره، وأسلافنا يزوروننا عبره، لكن الأهم من ذلك فأنه الطريق الذي يأتي من خلاله الأطفال الذين سيولدون”.
لكن أوبي كأن له رأي آخر فرد “الهدف الأساسي لوجود مدرستنا هو إقتلاع هذه المعتقدات من العقول، الموتى لا يحتاجون ممشى على الأرض، الفكرة بكاملها خرافة. مهمتنا هنا هي تعليم الأطفال أن يسخروا من مثل هذه الأفكار”.
ذات يوم صح مايكل أوبي من النوم ووجد السور كله مدمر لأن القرويين غضبوا منه خاصة بعد وفاة إمرأة أثناء الولادة، وشرح العراف أن الأسلاف غضبوا من إغلاق دربهم. بعدها وصل المفتش الأبيض الذي كأن أوبي ينوي إرضائه وإبهاره و لكن للأسف عندما أتى وجد فوضى عارمة في المدرسة، فكأن تقريره عن أوبي سيئ ووصف ما يحدث بين المدرسة والقرية بالحرب. وهكذا أنتهى أمر المدير الشاب.
ما ناقشه أشيبي في هذه القصة الممتعة هي العلاقة بين المعتقدات الأفريقية والتعليم الحداثي. فهناك أنتقاد سائد حتى الأن في أنحاء متفرقة من القارة أن الأسلاف يتواصلون مع الأحياء، حتى أن أرواح المواليد تأتي من الأسلاف، لذا يجب المحافظة على هذه الرابطة. وبالمقابل يرى أنصار التعليم أن هذه مجرد خرافات يجب محاربتها ودحضها.
دومة ود حامد
في قصة دومة ود حامد ناقش الطيب صالح الظلم الذي يقع على المواطنين البسطاء من قِبل النظام. كما ظهّر ميول صوفية في القصة خاصة شفاء الدومة للذين يقصدونها وذلك يظهر في مختلف أحلامهم.
لا أحد يعرف متى ظهرت الدومة إلى الوجود وكذلك ودحامد. فود حامد هذا كأن عبد تقي، إلا أن سيده كأن قاسي وفاسق وعندما ضاق ود حامد به ذرعاً طلب من الله أن يخلصه. فأتاه صوت أن يضع مصلاته على الماء. وبالفعل أخذته المصلاة إلى الدومة وهكذا أصبحت دومة ود حامد هكذا تستمر قصة الدومة التي تشفي كل مريض، فأتت الحكومة لتزيلها بحجة أنشاء محطة للباخرة تارة، و لوضع طلمبة ماء تحتها تارة أخرى. رفض الأهالي المحاولات المتكررة للحكومة، مما أدى لسجن عشرون رجلاً منهم. أدى بطش الحكومة إلى ثورة أسقطت الحكومة في نهاية المطاف, و خرج أنصار دومة من السجن أبطالاً.
من الملاحظ في القصة أن فكرة الدومة فكرة مجردة لنقل أشبه بالخيالي. فلا أحد يعرف متي نمت و هل ستبقى من جيل إلى جيل. ونجد أيضاً في القصة تمسك الأهالي بدومتهم، وإعتقادهم أنها تشفي الناس، فيقصدونها دون المستشفيات بالرغم من فقرهم وبُعد المسافة وعدم توفر وسائل النقل. على الرغم من كل ذلك إلا أن الأهالي رفضوا قطع الدومة، وكأنوا مستعدين للموت من أجل دومتهم، مما جعل بعضهم يدخل السجن. من الدلالات الأخري سعي السلطة الحثيث لتدنيس مقدسات المواطنين وإزالتها بغرض التنمية وتوفير الخدمات.
العلاقة بين قصة درب الموتى ودومة ود حامد:
فكرة درب الموتى جاءت من وحي المعتقدات المحلية لدى أشيبي وقد أراد أن يبين التعارض القائم بين التعليم والمعتقدات. كأنه يقول يجب أن لا تُزدرى هذه المعتقدات ففيها بعض الحقيقة. أما دومة ود حامد فليست مختلفة عن درب الموتى؛ فالأولي يأتي عبرها المواليد الجدد وعبر الدرب يزور الأسلاف أبناءهم وأحفادهم. بمعنى أن العالم الذاتي والموضوعي متداخل، بل وأن العالم الموضوعي عبارة عن إمتداد للعالم الذاتي.
فكرة درب الموتى جاءت من وحي المعتقدات المحلية لدى أشيبي وقد أراد أن يبين التعارض القائم بين التعليم والمعتقدات. كأنه يقول يجب أن لا تُزدرى هذه المعتقدات ففيها بعض الحقيقة. أما دومة ود حامد فليست مختلفة عن درب الموتى؛ فالأولي يأتي عبرها المواليد الجدد وعبر الدرب يزور الأسلاف أبناءهم وأحفادهم. بمعنى أن العالم الذاتي والموضوعي متداخل، بل وأن العالم الموضوعي عبارة عن إمتداد للعالم الذاتي.
الدومة مقدسة لدى أهالي البلدة ولذلك ناضلوا من أجلها ودخلوا السجن، كما رفضوا الخدمات مقابل نزعها. تماماً كما حدث مع مدرسة ندومي حين خربها القرويون. الدومة أيضاً تمثل فكر مجرد وأقرب إلى الصوفية في تناول معجزات الدومة ومحاولات الحكومة المتكررة لتدميرها.
نجد أن الأهالي رفضوا مقترح تغيير وقت زيارة الدومة وهو يوم الأربعاء حيث يذبحون ويعطون النذور للدومة. تماماً كما فعل القرويين حين إقترح المدير أن يتم تغيير الدرب مدعياً أن الأسلاف لن يجدوا مشقة في تعريجة بسيطة. من الملاحظ أنه على الرغم من أن المحطة مفيدة للأهالي وكذلك المدرسة للقرويين، إلا أنهم رفضوها لأنها تنهي واحدة من مقدساتهم وشيء ظلوا يتوارثونه عبر الأجيال. في قصة الدومة كأن بإمكأن القرويين أن يرضوا بطلمبة المياه ومحطة الباخرة تحت الدومة بشرط أن تظل واقفة، و في نفس الصدد فلم يكن القرويين متسامحين ولم يتساهلوا مع مدير المدرسة مع أن المدرسة في نهاية المطاف تفيد أبناءهم. فالمغزى هنا يتناول الظلم لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال, كما لا يمكن إزدراء معتقدات الغير بدعوى التقدم.
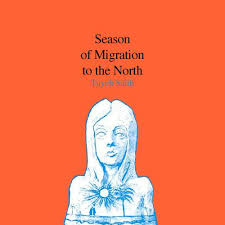
موسم الهجرة إلى الشمال
عرف الطيب صالح طريقه إلى العالمية عبر رائعته “موسم الهجرة إلى الشمال” والتي ناقش فيها العلاقة بين الشرق والغرب في شخصية مصطفىسعيد. تركت رواية موسم الهجرة إلى الشمال إنطباع جيد لدي بعد أن قرأتها لأول مرة عام 2010م، عرفت من خلالها أن الطيب صالح كاتب لا غبار عليه. في ذلك الوقت لم أكن قد قرأت له أي عمل آخر، ولكن أول إنطباع تركه إرتحت له لأنه دمج مختلف إتجاهات السودان، وهذا ما كنا نفتقده في كتابات معظم الشماليين حيث يظهر الجنوب في بعض الهوامش إن تم تناوله و غالباً ما يكون من باب تاريخ للحرب أو ما شابه ذلك. ولكن طريقة صالح كانت مختلفة، فالراوي من أقصى الشمال ووالده مصطفى سعيد من الجنوب. بعدما أكملت قراءة الرواية بحثت أكثر عن الكاتب فإكتشفت الكثير عنه. عرفت أن موسم الهجرة إلى الشمال لم يكن مجرد رواية، وإنما تناول العلاقة بين الشرق “المستعمَر” والغرب “المستعمِر” وكذلك مفهوم ما بعد الكولونيالية ولكن بشكل مختلف (مسودن) عن ما ذهب إليه بابا أو سعيد. نلاحظ في موسم الهجرة إلى الشمال إرتطام البيئة العربية (الشرقية) بالبيئة الغربية بعنف، ويمكن رصد هذا الإرتطام في عاملين، نرى خلالهما كيف تطورت الشخصية العربية في لهيب التعرف على الغرب على النحو التالي:
عقدة التفوق
الصدام بالغرب
شخصية مصطفى سعيد في هذه الرواية خير تمثيل لما يدور في أذهأن الشرقيين في التأقلم مع الغرب المختلف، وحتى إن تأقلم الشرقي فهو يظل يشعر بالنقص في حين أنه يجمع بين الهوية العربية والأفريقية معاً. ومع مزج الكاتب بين العروبة والأفريقانية في شخصية سعيد، إلا أننا نجد مصطفى سعيد مجتهد ويريد أن يصل إلى القمة من خلال ذكائه، وبالمقابل فهو في صدام دائم مع هذه الحضارة الغربية على الرغم من تشربه لها وإجادته للغتهم. جاء مصطفى إلى الغرب وتحت جلده عرق عربي (وأفريقي) عميق لا يستطيع الخلاص منه قط، وقد سعى للخلاص من المناخ العربي (الأفريقي) لكنه لم يستطع، ومن ثم حاول أن يلعب دور الآخر الأعلى والأرقى، و حاول أن يغزو الغرب كما غزانا الغرب من قبل. حاول أيضاً أن يتصرف بعقدة لا شعورية لإستبطان الشعور بالدونية للتخلص منه وقد كانت وسيلته إلى ذلك: الجنس.
”الأمور تتداعى”
هذه من أفضل ما كتب شينوا أشيبي على الإطلاق، و هنا أيضاً نجد أن الكاتب عرف طريقه إلى العالمية بهذه الروايةالتي تُعد من كتابات ما بعد الكولونيالية. قال أشيبي ذات مرة “يرضيني غاية الرضا أن تقتصر رواياتي على تعليم قرائها أن ماضيهم –بكل ما فيه من جوانب نقص- لم يكن ليلة طويلة من الوحشية”
تدور أحداث الرواية في بلدة أوموفيا شرق نيجيريا، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يتناول حياة الناس في القرية، و طرق حياتهم ومعتقداتهم. والثاني يتناول عمل الجمعيات التبشيرية في القرية. أما الثالث فيتناول دور المستعمر في أوموفيا. تتركز الأحداث حول حياة أوكونكو بطل الرواية، الذي إختار لنفسه طريق العمل الشاق والجهد حتى يمسح عار إرث والده أنوكا الكسول والجبان. أما أوكونكو فصار أحد أشهر رجال البلدة وأبرز مصارعيها، بل لُقِب بالقط لأنه لا يقع على ظهره على الإطلاق. يعيش أوكونكو بشكل طبيعي في قريته حيث المصارعة والزارعة والزواج. ولكنه في النهاية يتعرض لعقوبة الإبعاد من القرية لقتله أبناء جلدته عن طريق الخطأ، فيذهب إلى المنفى لمدة سبع سنين.
عندما يعود يجد المستعمِر قد وصل وكذلك المبشرين الذين غيروا وجه القرية كلها. فالكبار يتعرضون للإهانة من قبل البيض و المبشرين. دعى أوكونكو إلى إجتماع وحرض أهله على الثورة. و لكن عندها سمع المستعمِر خبر الإجتماع، أرسل مبعوثين لإيقافه، إلا أن أوكونكو الجسور والمغوار الذي لا يعرف الخوف أو الإنهزام قتل أحد المبعوثين- الشئ الذي جعله عرضة للحكم في محكمة البيض. المؤسف أنه لم يجد من أهل القرية السند اللازم، مما إضطره إلى الإنتحار لأنه وجد نفسه في غمرة من الإحساس بالغربة والإحباط فباشر بشنق نفسه <sup>9</sup>إستهجن أهل البلدة لهذا التصرف لأنه يخالف تعاليمهم بعدم القتل ولو عن طريق الإنتحار، وبالتالي إعتبروا أوكونكو جبان على الرغم من أنه الوحيد الذي ثار وتمسك بمبادئ أوموفيا إلا أن أبناء منطقته رأوا فيه الضعف بإقدامه على الإنتحار.
تكمن قوة أشيبي في هذه الرواية في ربطه بين الماضي والحاضر من خلال حياة و ثقافة مجتمع صغير. فأشيبي هنا أثبت للعالم- لا سيما العالم الغربي – قوة وحيوية الثقافة الأفريقية التي كانوا ينظرون إليها على أنها ليست سوي ثقافة همجية ولا يوجد فيها قيم إنسانية.
ما بين أشيبي والطيب
ما يجمع هذين الروائيين هو –حسب رأيي- إتجاههم الما بعد كولونيالي في طريقة كتابتهما. فالطيب تناول العلاقة التنافرية بين الشرق والغرب، حيث ينظرالغربي إلى الشرقي وكل ما هو شرقي على أنه همجي أو أقل منه حضارة. كما جرى على نسق رينان وغيرهم من المستشرقين الذين شرقنوا الشرق ووضعوه في قوالب أصبح الغربيين ينظرون إليها على أنها الصورة الحقيقية على مر أكثر من ثلاثة قرون. لذا فأن الشرقنة هي ما ساهم في ترسيخ بعض المفاهيم الترانسدنتالية حول الشرق وناسه. بنفس الإتجاه أيضا لم يسلم الغرب من محاكمة الشرق –ولو أخلاقيا- حول ما فعل في المجتمعات الشرقية. وهو ما وجدناه في شخصية مصطفى سعيد الذي حاول الإنصهار مع المجتمع الغربي بعد أن تعلم الإنجليزية وأصبح يتحدث به بطلاقة. فمع ذلك هناك شعور لا واعي (إن صح التعبير) يجعله ينظر إلى الغرب كآخر- ليس هذا وحسب بل يجب غزوه كما غزا أراضينا ونهب مواردنا.
كثر ما يميز صالح في “موسم الهجرة إلى الشمال” هو طريقة وضع سعيد بين العالمين الغربي والشرقي وبين ثقافات مختلفة كلياً، فمع أنه تشرب ثقافتين إلا أنه لم يستطع العيش في أي من البيئتين. فقد عاش في الغرب ولم يكن راضي بالحياة التي يعيشها وهو ما أحسه أيضاً عندما عاد إلى الوطن، حيث أنه أصبح أكثر غموضاً حتى النهاية التي لم يشرع الطيب في تحديدها.
في الإتجاه الآخر نجد أشيبي قد إستطاع أن يبرهن للعالم قوة وسلاسة الثقافة الأفريقية التي كان ينظر إليها الغربيين على أنها همجية كما سلف الذكر. وهو ما دحضه شينوا في “الأشياء تتداعى” حيث وقعت الأحداث في قرية صغيرة بشخصيات تعيش حسب طبيعتها الريفية، إلى أن جاء المستعمر والمبشر معه ليفسدا حياة القرويين المسالمين.
لعل القاسم المشترك بين أشيبي وصالح هو طريقة النهاية المأساوية لكل بطل في الرواية. نجد أن مصطفى سعيد قد إختفي فربما مات غرقاً أو إنتحاراً, بينما إنتحر أوكونكو ذاك البطل المغوار والملقب بالقط. من هنا إتفقا على نهاية غير جيدة وغير متوقعة للبطل والسبب يعود إلى عدم قبولهم أو قدرتهم على التعامل مع الواقع المرير المشبع بالتناقض بين الثقافة الغربية الدخيلة و الشرقية – أفريقية.
كتابات ما بعد الكولونيالية غنية بفكرة المقاومة والعودة إلى الجذور بل وترسيخ القيم الإنسانية للسكان المحليين الذين بطريقة أو أخري فقدوا الإرتباط بها نسبة لسياسات الكولونيالي الذي فرض قيمه الرأسمالية والإمبريالية الخفية في التعاليم الدينية والثقافية. خلال الكاتبين نرى أن من تلقوا التعليم على يد المستعمر من أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أصبحوا لا يقدرون معتقداتهم “الأسطورية” التي هي بداية طريقهم نحو الحياة بل وتحكم نظرتهم للكون من حيث التعامل والقواعد والسلوك. لهذا كتب كل من أشيبي والطيب وغيرهما من الروائيين وكتّاب القارة السمراء عن ما بعد الكولونيالية هي ما تجعلهم روائيّين من عالم واحد يناقشون نفس القضايا في مختلف المجتمعات في القارة. ولعل الهدف وراء تلك الكتابات هي إثراء الواقع الأفريقي بأعمال إبداعية تذكرهم بهويتهم قبل وخلال الإستعمار. فهل فعلاً إستطاع أشيبي وصالح الكتابة لما بعد الكولونيالية بشكل يحث على التفكير الذاتي على النطاق المجتمعي؟!
مراجع:
ادوارد سعيد- الإستشراق: المعرفة, السلطة, الأنشاء. مؤسسة الابحاث العربية 2010, نقله إلى العربية كمال ابو ديب- ص 80
أنظر لمدونة دينق ألينق
راجع: الطيب صالح, الاعمال الكاملة, مركز عبدالكريم ميرغني, الطبعة الاولي 2010م, ص 445
د. مصطفى عبدالغني, الاتجاه القومي في الرواية العربية, سلسلة عالم المعرفة 188 اغسطس 1994م, ص 97
الطيب صالح, الاعمال الكاملة, ص 65
المرجع السابق ص60
د. مصطفىعبدالغني, ص 98
د. على شليش, الأدب الأفريقي, سلسلة عالم المعرفة 112, يناير 1978م, ص 164
المرجع السابق ص165
